

أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ورقة تقدير موقف تخص الوضع
المغربي، تحت عنوان "المغرب: التعديلات الدستورية، إصلاح أم احتواء التحول
ديمقراطي".
وتشمل الورقة أربعة محاور رئيسة تنطلق من إضاءة حول نقاش التغيير في
المغرب، حيث تكشف الأرقام الرسمية والدولية أن الأوضاع الاقتصادية
والاجتماعية في المغرب لا تختلف عما هي عليه في بقية الدول العربية.
فهذا البلد ما زال يراوح مكانه، في خانة الشريحة الدنيا، بين البلدان
متوسطة الدخل، بينما استطاعت تونس والأردن والإكوادور مغادرة هذه الخانة
إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل.
وفيما يخص مؤشرات الفقر، يسجل تقرير البنك الدولي أن نسبة 20% الأكثر
فقرا في المغرب يستهلكون 8.5% من الدخل القومي، فيما تستحوذ نسبة 20%
الأكثر غنى على 47% من الدخل القومي. أما نسبة الأمية لدى المواطنين
المغاربة الذين تزيد أعمارهم على 15 سنة فلا تزال مرتفعة وتصل إلى 56%.
وتسجل تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية الكثير من الخروق
والانتهاكات التي لم تستطع السلطات المغربية التوقف عن ممارستها إلى اليوم.
كانت هذه الأوضاع وغيرها كافية لكي تدفع الشباب المغربي إلى إطلاق حركته
المطالبة بالتغيير تحت شعار (20 فبراير)، التي لقيت الاستجابة والدعم من
طرف مجموعة من القوى السياسية والإسلامية والمدنية.
ورفعت الاحتجاجات مطالب سياسية واجتماعية، أهمها: ملكية برلمانية يسود
فيها الملك ولا يحكم، وحل الحكومة والبرلمان، ومحاكمة المفسدين، والتوزيع
العادل للثروة الوطنية.
وبينما شكلت التعديلات الدستورية التي
أعلنها الملك محمد السادس في 9 مارس 2011 جوابا على مطالب التغيير، إلا
أنها لم تلق القبول عند القوى المطالبة بالتغيير، حيث رأى الشباب فيها
التفافا على مطالبهم، لا تقدم ملكية برلمانية، ولا تحد من سلطات الملك.
رحبت أغلبية الأحزاب المغربية (نحو 30 حزبا من أصل 34) بالتعديلات
الملكية، ورأى البعض أنها تجاوزت التوقعات، بينما رآها آخرون خطوة هامة نحو
الديمقراطيات العالمية العريقة.
فتحت التعديلات الدستورية في المغرب نقاشا واسعا حول النظام الملكي،
وسلطات الملك وطقوس البلاط، والثروة الملكية. واعتمد المؤيدون للدستور
أسلوبا يقارن متن الوثيقة الجديدة بسابقتها، بينما ركزت القراءة الرافضة
على مضمون الدستور.
رحب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بنتائج الاستفتاء على الدستور
الجديد (98.50%). ورأى فيها المؤيدون الكلمة الأخيرة للشعب المغربي، ودعوا
المعارضين إلى وقف احتجاجاتهم، بينما أكدت قوى 20 فبراير أن الشعب قاطع
الاستفتاء، وأن أرقام وزارة الداخلية مزورة ولا تعكس إرادة المغاربة، وأنهم
سيواصلون احتجاجاتهم.
سيناريوهات :
في ظل هذا التناقض يبقى سؤال التغيير في المغرب مفتوحا على مجموعة من السيناريوات، أبرزها باحثو المركز في ما يلي:
السيناريو الأول:
يعتقد بعض المراقبين أن المغرب يحاول تقديم نموذج للتغيير لم يحدث في
باقي البلدان العربية، خاصة في تونس ومصر، حيث ساهم انضمام المؤسسة
العسكرية إلى مطالب الشعب في حسم الموقف، مما يرجح بقوة، فرضية التغيير
التدريجي والسلمي في المغرب. ويتوقع رواد هذا السيناريو أن يطلق محمد
السادس دينامية سياسية مجتمعية تبدأ أولاً بخلق أجواء الثقة بين السلطة
والفاعل الجديد (قوة الشارع)، ثم مع الأطراف المعارضة، خاصة جماعة العدل
والإحسان، من خلال إجراءات محددة، ربما قد تشمل تمكين الجماعة من ممارسة
العمل السياسي، وفتح قنوات مستمرة للحوار مع قياداتها، وإطلاق سراح ناشطي
حركة 20 فبراير وباقي المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفتح أبواب
الإعلام العمومي أمام الرأي المخالف، إضافة إلى تصفية ملفات الفساد
الاقتصادي والسياسي، وإبعاد بعض الأسماء المشبوهة من المحيط الملكي،
والقضاء على اقتصاد الريع والامتيازات في مختلف المجالات.
ويعتقد أصحاب هذه الرؤية أن النظام سيمارس عملية احتواء لمعارضيه، لكنه
في المقابل سيُخضع ذاته لنوع من التغيير، وفي حال حصول هذا التحول، قد يجد
المعارضون أنفسهم أمام مبادرة مشجعة للمشاركة السياسية، خاصة أن لا أحد
منهم- حتى اليوم- دعا إلى إسقاط النظام أو استخدام العنف لتحقيق برامجه
السياسية والمجتمعية.
السيناريو الثاني:
ينبني هذا السيناريو على فكرة أن النظام المغربي لم يستوعب التحول
التاريخي الذي يشهده العالم العربي. لذلك لم يفكر النظام في إحداث تغيير
حقيقي، بقدر ما حاول قدر الإمكان الانحناء للعاصفة، والدليل أنه استخدم
–دائما- التعديلات الدستورية كأداة لصناعة المراحل والالتفاف على ضغوط
التغيير (6 تعديلات في 49 عاما). وعلى هذا الأساس، يتوقع هذا السيناريو أن
النظام سيلجأ في ما بعد إلى تهميش وتحييد كل منافسيه الأقوياء، ويمكنه في
مرحلة أولى أن يلجأ إلى إقناع مكونات "20 فبراير" بفكرة تأسيس حزب سياسي،
ثم الدخول إلى الساحة السياسية بصفة فاعل معارض معترف به، ثم ينتقل في
مرحلة لاحقة إلى توظيف الاختلافات الإيديولوجية الموجودة بين الفاعلين في
هذا الحراك الشبابي، ثم يدفع به في النهاية إلى الانقسام، وهي آلية معروفة
استخدمتها السلطة مرارا لكسر معارضيها في تاريخ المغرب السياسي. ووفقا لهذا
السيناريو سيكون الوقت سلاحا أساسيا، إضافة إلى صناعة القضايا والأحداث
الجانبية التي ستستنزف طاقة حركة 20 فبراير وتشغل الرأي العام المغربي إلى
حين.
السيناريو الثالث:
يرى أصحاب هذا التوقع أن مفعول التعديلات الدستورية لم يكن مؤثرا.
ودليلهم أنه بعد إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء مباشرة، خرجت في مدن
المملكة تظاهرات رافضة ومصرة على مواصلة الاحتجاج، وحدثت في مدينة خريبكة
ومحيطها الغني بالثروات الفوسفاطية، انتفاضة عنيفة للعاطلين.
ويعتقد أصحاب السيناريو الثالث أن فشل إقرار الدستور الجديد في إخماد
الحركات الاحتجاجية، يعود إلى اعتماد الملك على الأحزاب (30 حزبا تقريبا)
التي لا تحظى بقاعدة انتماء شعبي قوية في ترويج مبادرته الدستورية. فقد
أشارت مصادر إعلامية إلى أن الدولة صرفت لبعض الأحزاب نحو 9 ملايين دولار
عشية التصويت على الدستور، مع العلم أن التعديلات الدستورية لم تكن من
مطالب هذه الأحزاب التي تعاني منذ سنوات عزلة داخل المجتمع المغربي، لذا
تدافع هذه الأحزاب عن النظام سواء عدّل الدستور أم لم يعدّله.
ورأى آخرون أن الأساليب التي استخدمتها السلطة لإقناع المواطنين
بالموافقة على الدستور جاءت بنتائج عكسية. ولاحظوا أن هذه التعديلات أعادت
إلى الساحة المغربية نقاشا واسعا حول النظام الملكي، وإمارة المؤمنين،
وسلطات الملك، وطقوس البلاط الملكي، مما نقل عملية استفتاء من تصويت على
الدستور، إلى محاولة لتأكيد شرعية الملكية.
ويبدو أن كل الإجراءات التي قامت بها الحكومة لمحاصرة الغضب الشعبي، من
إطلاق أو تأسيس مجالس مختلفة، وإطلاق سراح مجموعة من المعتقلين السياسيين،
ورفع أجور الموظفين، وتشغيل مجموعة من العاطلين حملة الشهادات العليا،
وإعفاء صغار الفلاحين من القروض، إضافة إلى سحب العائلة الملكية يدها من
الاستثمار في المواد الأساسية في السوق الوطنية؛ لم توقف الاحتجاجات
المهنية والشبابية، والتي أخذت منحى نوعيا بعد خروج مئات من أئمة المساجد
والمؤذنين إلى الشارع مطالبين بالإنصاف وعدم تدخل وزارة الداخلية في
شؤونهم.
بناءً عليه، يرى المرجحون لهذا السيناريو أن بإمكان النظام المغربي أن
يتجاهل الاحتجاجات الشعبية على المدى القصير، مع استخدام معالجات أمنية
جانبية وغير شاملة، حتى لا يثير انتقادات الإتحاد الأوروبي والولايات
المتحدة، مع المراهنة على دعم الأحزاب بإرضائها في الانتخابات التشريعية
المنتظرة.
وهنا يُحتمل أن تطور الاحتجاجات أساليب عملها وأدوات اشتغالها، لتعمق
تواصلها داخليا وخارجيا، وقد تجلب إليها الفئة التي ظلت صامتة حتى الآن،
وربما يساهم التغيير الذي لحق النص الدستوري بعد التصويت عليه، في دفع فئة
من المؤيدين للدستور إلى فقدان الثقة في النظام، بعد أن تسفر الوعود
الحكومية عن واقع أكثر تأزما وتعقيدا.
ونتيجة هذا المسار التصاعدي، يمكن أن نكون قريبين من الحالة المصرية،
ليس من ناحية نتائجها بالضرورة، ولكن على الأرجح من جهة صيرورتها، حيث
ستتسع الحركة الاحتجاجية وتتنوع أنماطها قبل أن تتفجر الأوضاع. وربما يرتفع
سقف المتظاهرين في الساحات والفضاءات العمومية. ولن يكون أمام السلطة
حينئذ أي مجال لاحتواء قوة الشارع أو التخفيف من الاحتقان، لأن عامل الزمن
لن يتيح لها الفرصة لاستعادة زمام المبادرة.








 هوِّر يابو الهوَّارة .. بلادي ارض الحضارة يلي ما بيعرفها منيح يرافقني ليها زيارة
هوِّر يابو الهوَّارة .. بلادي ارض الحضارة يلي ما بيعرفها منيح يرافقني ليها زيارة

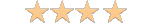


 عدد المساهمات
عدد المساهمات السٌّمعَة
السٌّمعَة تاريخ التسجيل
تاريخ التسجيل

 19.07.11 15:06
19.07.11 15:06




